
كانت تفجأنا صور مؤلمة لطفل مزقت سياط التعذيب جسده الغض كل عام مرة أو مرتين، ثم ننسى أو نتناسى في زحمة الأحداث دون أن نتعظ ونعتبر، أو نتخذ القرارات ونضع البرامج اللازمة للحماية والوقاية، وهو ما أوصل للفاجعة الأخيرة التي هزت الرأي العام، رزق الله ذوي الفقيد الصبر وأعظم لهم الأجر، ومما يزيد الحسرة أن أصابع الاتهام تتجه –كل مرة - لمعلمي المدارس وشيوخ المحاظر، الذين هم أمناء على تربية وتهذيب النشء، وغرس الأخلاق وتعزيز القيم السمحة في هذا الزمن الصعب، الذي تتشابك فيه المؤثرات وتتعدد المخاطر المهددة للجيل الجديد، في عالم سمته موت الجغرافيا وزوال الحدود والقيود، وتسلل الشهوات والشبهات للبيوت والقلوب دون استئذان.
ولا شك أن هذا العدوان مدان، إذ ليس يقره عقل ولا دين، ومن حق ذوي الضحايا ملاحقة الجناة، وعدم قبول التسويات القبلية التي تحمي المجرمين والمقصرين، وعلى حملة الأقلام وتجار الكلام ترك لغة الحسم والجزم للجهات المعنية، ومنع تحول الأحداث إلى تراشق في فضاءات التأثير، وساحة لتصفية الحسابات والتجاذبات، مع ضرورة التثبت في مثل هذه الحالات، فأعداء الدين والمحظرة كثر، والمتاجرون يختلقون الأكاذيب فيزيدون وينقصون، وقد حصل ذلك في مرات سابقة، وكما لا يجوز أن نتهم دون بينة فإن علينا كذلك الكف عن منح صكوك البراءة، فإن ثبت الجرم لزم إنزال العقوبة بقدره، دون تساهل في إنصاف الضحايا.
ومع اعترافنا باستهداف منظومة المحظرة، وكيل التهم جزافا لمنسوبيها من خصوم الدين وأصحاب اللوثات، فإننا لا نسوق أو نسوغ ضياع الحقوق، أو نتردد في الاعتراف بالقصور أو التقصير إن حصل، فليس كل ما يقال عنا غير صحيح، وليس الاستهداف مانعا من النقد والتقويم الذاتي، الذي هو سبيل التطوير والارتقاء، وأزعم هنا أني غير متهم على منظومة المحظرة، وأني أملك الحق في المصارحة والمناصحة، فقد لبثت فيها عمري كله، دراسة وتأسيسا وإدارة وتدريبا بحمد الله، أقول هذا قطعا لتهمة التحامل، وتترسا من النيران الصديقة.
إن المحظرة تعليم أهلي غير منظم، نشأ على ظهور العيس، ثم جاءت به وبنا ظروف قاهرة من البدو، ولا تزال متطلبات التنظيم والضبط المؤسسي حلما بعيد المنال، رغم الجهود المشكورة من بعض الفاعلين المحظريين في السنوات الأخيرة، ففي دراسة استبيانية شملت عينة من محاظر العاصمة – التي هي أكثر تنظيما في الجملة – أجريتها حديثا اتضح أن نسبة 13% فقط من المحاظر المشمولة بالدراسة تملك خطة ناظمة للنشاط، وأن الهياكل التنظيمية تخلو غالبا من وظائف تتصل بأنشطة الرقابة والضبط، ثم إن البداوة والتلقائية روح تسري خلل كل كيانات الدولة والمجتمع، وليست المحظرة استثناء بالضرورة.
لقد مكنتني برامج الإشراف والتدريب من الاطلاع على نظام كثير من المحاظر، فلمست وعيا متزايدا بمنع التعنيف اللفظي والجسدي، وتطبيق الجزاءات على المخالفين، وانتهاج الأساليب التربوية لمعالجة الانحرافات السلوكية عند الأطفال، لكن كل ذلك لم يكن كافيا للقضاء على الظاهرة، والمعالجة الجذرية لأسبابها، وإلا لما استمرت الأخطاء والتجاوزات، التي هي خصم من رصيد المنظومة المحظرية، باعتبارها حاضنة مستأمنة على تربية وتعليم فلذات الأكباد.
بين القصور والتقصير
يستوقفني - في واقعنا المجتمعي - الخلط الكبير بين "القصور" و "التقصير"، لذا قل أن نجد من يتقبل المراجعة والتقويم والمساءلة بصدر رحب، مما يولد حالة مزمنة من مقاومة التغيير ورفض التطوير، والوقوف حجر عثرة في سبيل إنصاف المظلومين ومعالجة الأخطاء، مع أن القصور أمر ملازم للعمل البشري، والوقوف عليه ومعالجته شرط للاستدامة وحفظ الحقوق، أما التقصير - الذي هو قصدٌ وعدمُ بذل للوسع في أداء المسؤولية على الوجه الأكمل - فإننا لا نتهم به أيا كان دون بينة.
أين الخلل؟..
من متابعة واقع الميدان لثلث قرن يمكنني الجزم بأن العنف اللفظي والجسدي ظاهرة مجتمعية متجذرة، والمحظرة بنت المجتمع، لذا لا تتحمل المسؤولية بمفردها ولا تملك العلاج، ومثلها المدرسة التي لا تقل عنها قسوة من واقع تجربتي على الأقل، وعليه لا مناص من تكامل جهود الدولة والمجتمع والنخب لفهم أفضل للظاهرة ووضع مقاربات جادة لمعالجتها، تتكامل فيها جهود التوعية والتأهيل والضبط والتنظيم، فقد لمست مقاومة شديدة من بعض أولياء الأمور لمنع التعنيف، بل إن منهم من يعتدي على حرمة المحاظر أحيانا لتأديب أبنائه!.. ومن التقليديين من لا يستسيغ وجود تعليم دون ضرب، لأنه كان ضحية التعذيب، وورث القسوة بالسند المتصل، و"التعذيب في الصغر" قد يترك عقدا نفسية وحاجة للتنفيس عند الصباح وعند المساء.
المحاظر ذات السلاسل
وليس أدل على مسؤولية الدولة والمجتمع من وجود محاظر معلنة تنتهج أسلوب التعنيف والتقييد بالسلاسل على مرأى من الجميع، قد استفاضت عنها الروايات وانتشرت الصور دون أن يتحرك ساكن، ثم إن العائلات التي تسلم صغارها لهذه المعسكرات على بينة من الأمر، لكنها في الغالب بين خيارين أحلاهما مر: إما الجنوح وتعاطي المخدرات وإما التعذيب، ومن المفارقة أن الأمة يتهدد أطفالها خطر المخدرات والمسكرات، ويتزايد فيها فتك عصابات السكاكين، ومع ذلك تتجاهل الدولة والمجتمع الموضوع بشكل شبه تام: لا مكافحة - لا توعية - لا علاج!.. والفاعلون التربويون والدعاة والمصلحون كذلك خارج التغطية: لا تحسيس - لا مراكز استشارات - لا برامج إقلاع.
ومن تجليات تقصير الدولة والمجتمع كذلك غياب الاهتمام بالصحة والسواء النفسي لشاغلي الوظائف التعليمية والتربوية، وكأنهم اكتُتبوا دون مقابلات تقويم شخصي جادة، إذ لم تخل مدرسة في مسيرتنا التعليمية من مجنون أو مجبون، يبطش باليد واللسان، وكانت المؤسسات تفتقر كذلك للمتخصصين في الارشاد النفسي والتربوي، وحين ناقشت هذه الحقيقة مع بعض الفاعلين التربويين كان الرد: الخلل عام!.. وفي كل إدارة مجنون (ول مج بعد أل فم).
بين التعذيب والتأديب
في سياقنا هذا تَستبعِدالقراءة الواقعية الحديث عن خيار ضرب التأديب، وإن سلمنا بقبوله تأصيلا لزم منعه تنزيلا، هذه قناعة تولدت بعد مناقشة كثير من أهل التحقيق والتدقيق، مبنية على كثير من الاعتبارات الشرعية والواقعية، منها:
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم ومعاملة الأطفال، إذ لا معلم قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، لا ينهر ولا يضرب ولا يشتم، كما في حديث معاوية السلمي عند مسلم، والوقائع التي تعكس عطفه ورحمته ولين جانبه مستفيضة في الأحاديث الصحيحة الصريحة.
ثم إن المحظرة ومنسوبيها لا يملكون حق ضرب التأديب، إذا ليسوا أولياء ولا موكلين، فأولياء الأمور - خاصة في العاصمة والمدن الكبرى - يشترطون عدم التعنيف، وحتى لو طلب الولي التأديب فإنه ينقلب عند أول اختبار، وقد تأتي الطامة من غير الولي، من القريب أحيانا، وحتى من الغريب أحايين.
لا حد يفصل بين التأديب والتعذيب في واقعنا، وقصد التأديب يجر غالبا لجريمة تعذيب، فالمدرس يؤدب حال الغضب للتنفيس، وقد يعتذر بأنه كان فاقد الوعي تماما بما حصل!.. وكل من تسبب في عاهة لم يكن يقصدها، وحتى إن وجد من تسبب تقصيره في القتل لم يقصد ذلك على الأرجح، وعليه لزم الاحتياط.
المقاربات التربوية والتحفيزية أنفع لهذا الجيل الواعي بما يحيط به، والذي يرفل في نعمة الدلال، ويتعرض لوسائل تأثير تتنافس كلها في كسبه، ومن اللازم إدراك هذه التنافسية، والسعي لكسب العقول والقلوب.
أما المفاسد التي تترتب على التعذيب فلا تقع تحت حصر، ولا مقارنة البتة بينها وبين ما يتوقع من منافع، فالمحظرة نظام مفتوح يتأثر بالبيئة المحيطة، ومُطالب بالتعامل والتكامل معها، وتفهم متطلباتها وإكراهاتها، ولا مكان للتفكير بمنطق: "كان شيخي يضربني"!.. أو "لولا الضرب لم أحفظ القرآن"!.. لأن ذلك كان قبل عقود، وكان في أعماق الأعماق في بيئة تتفهمه.
والتعنيف بدل التحفيز والتحبيب يفضي في الغالب إلى بغض المحظرة وكل ما يتصل بها، وقد يكون المدرس الغافل سببا للإلحاد والكفر، وقد يخلق العقد والأمراض النفسية لضحاياه، ومن المؤلم ما أسر به إلي أحد الشباب حين قال: والله إني لمسلم محب لديني، لكني – أعوذ بالله من حاله – لا أستطيع أن أحتمل قراءة آية من كتاب ربي وقد حفظته في صغري!.. فكل آية تذكرني بلكمة أو شجة أو صفعة أو سوط، والاثم - يضيف المسكين - على مدرسي، وبيني وبينه يوم الحساب.
أحبتي الغيارى!..
أهل القرآن والإيمان!..
رجال الذكر والفكر!..
وظفوا هذه الغمة في المراجعة والتسديد، وحاصروا الأخطاء وتحوطوا لها..
اجعلوا علاقتكم بطلابكم: (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)..
من أمكنكم نفعه بالتي هي أحسن فذاك، ومن تعذر ضبطه أو استفادته ردوه إلى أهله سالما دون جروح جسدية أو ندوب نفسية..
قد يبدو مقترحا سهلا ميسورا، لكنه والله صعب لشهوة التحكم ورسوم المشيخة، ولداعي الإلف وهوى النفس والشيطان..
هذه فرصتكم لتعميق الوعي بخطر وخطل التعنيف، وستدركون الأثر ولو بعد حين، فقد صرح لي أحد الفضلاء: تطلب فهم ما أرشدتني إليه خمس سنين كاملة غير منقوصة، فكان ردي: حول هذا أدندن مع زملاء لربع قرن ولما يقلعوا عن إدمان التعذيب بدعوى التأديب


.jpeg)

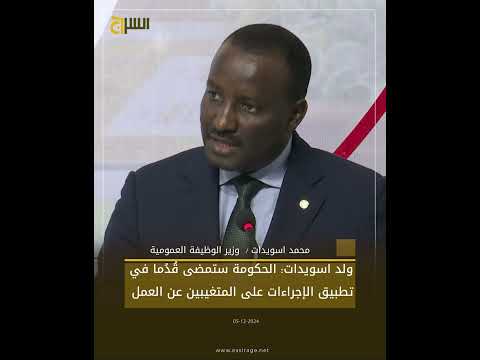








.jpg)